التبويبات الأساسية
داريا.... شهيدةً وشاهدة

من كان يتوقع أن داريا الوادعة المستلقية على ضواحي دمشق القريبة سترتقي يوماً لمقامٍ تُصبح فيه (شهيدةً) بالمعنى الإنساني الكبير للكلمة، وبشكلٍ لاتنحصر دلالاته في سوريا وحدها، بل تمتد بإشعاعها إلى العالم بأسره.
لكنها قبل أن تنال ذلك المقام، وبعده، فَرضَت نفسها (شاهدةً) على حقائق ووقائع ومعاني كُبرى، شاهدةً على عظمة الإنسان وكمونه، وقدرته الفذة على الإبداع في التعامل مع واقعه الصعب بأساليب وطرق في التفكير، فيها من معاني الابتكار مالم يخطر على بال أحد. شاهدةً على إنتاج خطاب وممارسة ندرَ أن يرى لها التاريخ مثالاً.
لكن قَدَرَهها شاء أن تكون شاهدةً أيضاً، في الدنيا والآخرة، على كل معاني الضعف البشري والخُذلان والأنانية والحسابات الضيقة بكل معانيها، ومن قبل أطراف، دولية وإقليمية ومحلية، نعرف حجم الألم الذي يطعننا حين نفكر فيها.. وحجم تلويث تلك الأطراف بمعاني من الخذلان التي لايمكن أن يُغسل عارُها لزمنٍ طويل.
أكثر من هذا، باتت هذه البقعة الملائكية، بأهلها وناسها، بؤرة تفكير وممارسات في غاية الفرادة، تكاد تتميز عن أي منطقةٍ أخرى، تتعلق بالتوازنات المدروسة الدقيقة القادرة على الجمع بين معاني يحسبُها السوريون متناقضة. ففي داريا لم ينحصر الأمر فقط في (تعايش) رؤىً مختلفة، اجتماعية وثقافية وعسكرية واقتصادية وقضائية، قد تكون في جوهرها النهائي متباينة في قليلٍ أو كثير، لكنها، في داريا تحديداً تجاوزت مصطلح التعايش المحايد، لتنتقل إلى درجاتٍ من التعاون والتنسيق والتكامل والتفاهم والقدرة الفذة على التعامل مع الاختلاف ومقتضياته، وصولاً لتجاوزها، ثم إلى خلق واقعٍ مثالي بكل معنى الكلمة، خاصةً إذا ماأخذنا بعين الاعتبارالوضع الاستثنائي الخطير والضاغط لداريا، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وعلى بعد مرمى حجر من الكتلة الكبيرة للقوة العسكرية الوحشية للأسد. وهذا في النهاية سيبقى نموذجاً نظرياً ومعملياً من المؤكد أن الاستفادة منه في سوريا الجديدة قادمة.
يكثر الكلام الواجب عن داريا. لايمكن حصره في هذا المقال. وثمة مسؤوليةٌ كبرى على الجميع، من داريا وخارجها، على الكتابة في ذلك، والأهم من هذا توثيق هذه التجربة الحضارية الاستثنائية بكل أبعادها. ليس فقط للتاريخ والأجيال، وهذا ضروري، ولكن للدراسة التاريخية والاجتماعية لهذه الظاهرة التاريخية الفريدة.
ثمة كلماتٌ وجدانية أوردَ الإنسان سابقاً بعضَها في الحديث عن حمص يوم حصارها الأسطوري، وأشعر، دون تكلف، أنها تنطبق اليوم، بقوة، على الوضع في داريا وعلى أهلها، فأستميح العذر في تكرارها، ولوبتصرفٍ يناسب المقام.
رُفعت الأقلام وجفّت الصحف. وفرَضَت داريا نفسَها أيقونةً ومنارة للربيع العربي دون منازع. ومهما حدث بعد اليوم، سيبقى مَثَلها قصةً للسموّ الإنساني ترويها أجيال العرب إلى يوم الدين.
حملت داريا لواء ثورة الحرية والكرامة مبكراً، حتى قبل انطلاق الثورة كما يعرف الكثيرون. ورفَعت اللواء عالياً، ثم ارتفعت معه عملياً إلى عنان السماء، ليس بالشعارات والنظريات، وإنما بممارستها العملية. ورغم أن داريا دفعت ولاتزال تدفع الكثير ثمناً لذلك، لكن اللواء لم يسقط من يدها على الإطلاق. حتى بعد التطورات الأخيرة.
لاعجب أن يُصاب النظام السوري بالجنون ليفعل بالمدينة مايفعله منذ سنوات. فقد كان يعرف دائماً أن بقاء اللواء مرفوعاً بيدها رغم كل تضحياتها يمثّل أكبر طعنةٍ لكبريائه التي باتت ممرغةً بالتراب.
منذ أشهر، كان النظام يفعل الأفاعيل ليُطفىء الجذوة التي تُشعلها داريا. لكنها كانت تصرّ دائماً على أن تبقى شوكةً في حلقه، وعلى أن تكون القدوة والنموذج.
كانت خلاصة القصة: لم تعد داريا لحظةً إلى الوراء، ولم تتحرك أبداً إلا إلى الأمام.
كان هذا قبل أن يزجّ النظام بكامل قوته العسكرية في ألف معركة خاسرة، ضدّ أبطال داريا.
وحين بقيت صامدة، صبّ جام غضبه عليها، عسكرياً هذه المرة، استمرّ القصف والحصار أياماً طويلة ولكن، مرةً أخرى، خرجت المدينة من محنتها كالعنقاء.
وهاهي اليوم قد عاشت الفصل الأخير، المؤقت بأعمار الشعوب، من قصتها الفريدة. أسابيع طويلة من قصفٍ متواصل وحشيٍ عن بُعد، لايمارسه إلا الجبناء.
رضيت داريا بالشهادة إذاً في نهاية المطاف بمعنىً من المعاني، لكنها باتت أصدق شاهدٍ في هذا العصر على موت الإنسانية.
لن نتحدث عن نظامٍ عالميٍ يُثبت مرةً تلو الأخرى حجم نفاقه، حين يكون عاجزاً وقتما يريد وقادراً عندما يشاء.. لكن السؤال صار مشروعاً حول قدرة العربي والمسلم على النظر إلى نفسه في المرآة، دون أن يشعر بعجزه وخذلانه العميق تجاه إخوته في سوريا.
باختصار، غادرت داريا، إلى أبد الآبدين، هامش التاريخ، ونقلت نفسهاً لتكون فصلاً رئيساً في متنه، وتصبح عنواناً من عناوينه الكبرى. ستعود داريا، وسيعود أبطالها، دون طويل غياب. وستتابع كتابة تاريخها الباهر. والذي شاهد معنويات أبطال داريا في طريقهم لشمال سوريا، يدرك أن هؤلاء سيكونون نواة بطولات هناك، وفي كل مكان ٍ آخر، بحيث يندم نظام الأسد ألف مرةٍ في المستقبل على السماح لهم بالمغادرة.
لكن السؤال الكبير يبقى: بأي درجةٍ من الخزي والعار سيكتب التاريخ، فصوله التي لن تُمحى بعد ذلك، عمن يتفرجون عليها؟



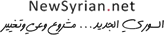









علِّق